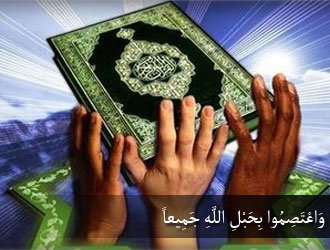عندما تتحدث الأيديولوجيا باسم التاريخ: قراءة في خطاب بلغيث الإقصائي.
اثارت التصريحات الأخيرة للباحث الجزائري محمد الأمين بلغيث، التي أدلى بها في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، جدلاً واسعاً ونقاشاً حاداً في الأوساط الثقافية والسياسية، خاصة في منطقة شمال أفريقيا. جاءت هذه التصريحات رداً على سؤال حول آرائه المثيرة للجدل بشأن الهوية الأمازيغية، حيث قدم بلغيث وجهة نظر راديكالية تنفي وجود هذه الهوية ككيان ثقافي أصيل. وفقاً لما نُقل، وصف بلغيث "الأمازيغية" بأنها "مشروع أيديولوجي صهيوني فرنسي"، منكراً وجود ثقافة بهذا الاسم ومؤكداً على أن "البربر" هم "عرب قدماء" استناداً إلى مصادر تاريخية. كما اعتبر أن القضية الأمازيغية برمتها هي مشروع سياسي يهدف إلى "تقويض وحدة المغرب العربي" خدمةً لأجندة فرنسية. واختتم بالإشارة إلى أصول فينيقية كنعانية مشتركة لشعوب المنطقة. إن هذه الآراء، التي تتعارض بشكل مباشر مع السرديات السائدة والاعتراف المتزايد بالبعد الأمازيغي في هويات دول شمال أفريقيا، تستدعي وقفة للتحليل والمناقشة، نظراً لما تحمله من تداعيات على فهم التاريخ والهوية والنسيج الاجتماعي في المنطقة.
وبعيدًا عن مجرد نقل هذه التصريحات، يبدو أن ما قدمه الدكتور محمد الأمين بلغيث في تصريحاته الأخيرة لا يندرج ضمن إطار السرد التاريخي الأكاديمي المتجرد، بقدر ما يعكس قناعة أيديولوجية راسخة تنطلق من منظور محدد. فالانتماء الواضح للتيار القومي العربي هو الذي يبدو أنه وجّه عدسته نحو قراءة تاريخ الجزائر وشمال أفريقيا، مما أدى به إلى تبني موقف ينطوي على إلغاء مكون أساسي وأصيل من مكونات النسيج الاجتماعي والثقافي لهذه المنطقة، ألا وهو المكون الأمازيغي. إن محاولة نفي وجود الأمازيغية كثقافة وهوية، واعتبار "البربر" مجرد "عرب قدماء"، يشبه إلى حد بعيد، مع مراعاة الفوارق السياقية، الذهاب إلى الولايات المتحدة والادعاء بعدم وجود السكان الأصليين (الهنود الحمر)، متجاهلاً بذلك تاريخاً طويلاً ومعترفاً به ووجوداً مادياً وثقافياً لا يمكن إنكاره. يكمن جوهر الإشكالية إذن في أن الفكر الأيديولوجي، بطبيعته الانتقائية والموجهة، يجب أن يبقى منفصلاً قدر الإمكان عن عملية البحث والسرد التاريخي التي تتطلب الموضوعية والحياد والتعامل النقدي مع المصادر المختلفة. فالخطأ الجوهري الذي يقع فيه هذا الطرح هو استبدال التحليل التاريخي بموقف أيديولوجي مسبق، مما يقود حتماً إلى تبسيط مخل للتاريخ، والأخطر من ذلك، إلى إقصاء وتهميش شريحة واسعة من المواطنين الجزائريين والمغاربيين الذين يرون في الهوية الأمازيغية جزءاً لا يتجزأ من كيانهم وتاريخهم. إن النظر إلى التاريخ من خلال زاوية أيديولوجية ضيقة يهدد بفقدان البوصلة البحثية ويحول التاريخ إلى أداة للصراع بدلاً من كونه مجالاً للفهم والمعرفة.
وهذا المنظور الأيديولوجي، الذي يغلب التاريخ، لا يخلو من تداعيات خطيرة. فقد يبدو للوهلة الأولى أن الخوض في قضايا الهوية الشائكة، مثل قضية الأمازيغية، ينبع من حرص على "الثوابت الوطنية"، لكن بعض الطروحات المتطرفة، كتلك التي تنفي وجود مكون أصيل كالأمازيغ، قد تحمل في طياتها مشروعاً مضاداً. فبدلاً من التثبيت، يمكن أن تتحول إلى أداة لتهديم النسيج المجتمعي وتفكيكه من الداخل، عبر زرع بذور الشقاق واللااستقرار بين أركانه. فعندما يُصرّح بعدم وجود الأمازيغ، على الرغم من الاعتراف الدستوري الصريح بهم كجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية، فإن هذا لا يُعد مجرد رأي، بل هو بمثابة محاولة لإثارة الشارع ودفع هذا المكون الأصيل إلى دائرة رد الفعل. إنها دعوة ضمنية، وربما مقصودة، لتحفيز الأمازيغ على "التعبير عن وجودهم" كرد على محاولة نفيه. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف يُتوقع منهم التعبير عن هذا الوجود إلا كرد فعل على محاولة نفي كيانهم ذاته؟ لذلك، إن تحصين الأمة ووحدتها يقتضي، بالضرورة، عدم المساس بثوابتها الراسخة، ومن ضمنها الاعتراف بالتنوع الذي يشكل ثراءها، بما في ذلك المكون الأمازيغي. فالأجدى ليس إثارة المسائل الخلافية التي تفرق ولا تجمع، بل العمل على توحيد الصفوف وتوجيه الطاقات نحو المستقبل. إن ترك الجزائريين، بكل مكوناتهم، يتنافسون في ميادين البناء والتنمية هو السبيل الأمثل لتعزيز الوحدة الوطنية الحقيقية، لا عبر محاولات إلغاء الآخر أو التشكيك في وجوده.
وفي محاولة لفهم جذور مثل هذه الطروحات المثيرة للانقسام، تلامس تصريحات الدكتور بلغيث، للأسف، وتراً حساساً وحقيقة قد لا يُجهر بها صراحة في كثير من الأحيان: وجود فئة، ربما ليست بالقليلة، لا تزال تكافح لقبول فكرة التعايش الحقيقي والمتناغم بين مختلف مكونات المجتمع الجزائري والمغاربي. يبدو أن هناك من هم غير مقتنعين بإمكانية أو حتى بجدوى تعايش "العربي" مع "الأمازيغي" ككيانين متمايزين ومتساويين، أو ربما تمتد عدم قناعتهم لتشمل رفض التنوع الأوسع، كقبول التعايش بين المتدين وغير المتدين. ورغم أن هذا الرفض قد يمثل واقعاً لدى البعض، فإن التعبير عنه علانية، وبهذه الحدة التي تصل إلى نفي وجود الآخر، يتجاوز حدود حرية الرأي ليصبح نوعاً من التطرف الفكري. فالتصريح بأن "لا وجود للأمازيغية" ليس مجرد تحليل تاريخي، بل هو موقف إقصائي ينبع من عدم القبول. إنه شكل من أشكال التطرف الذي يمارسه تيار يرفض الآخر ويسعى لإلغائه هوياتياً. ومن باب الإنصاف، يجب الإشارة إلى أن هذا النوع من التطرف ليس حكراً على جهة واحدة؛ فكما قد يوجد متطرفون عرب يرفضون المكون الأمازيغي، قد يوجد أيضاً متطرفون أمازيغ يتبنون خطاباً إقصائياً مماثلاً تجاه المكون العربي. وفي كلتا الحالتين، إن كِلا شكلي التطرف، بغض النظر عن مصدره، يمثل خطراً داهماً على النسيج الاجتماعي، لأنه يغذي الكراهية ويزرع بذور الفرقة بدلاً من البحث عن المشترك وبناء جسور التفاهم. والأهم من ذلك، أن إطلاق مثل هذه التصريحات، حتى وإن كانت تعبر عن قناعة "حقيقية" لدى قائلها، يتجاهل أبسط قواعد الاحترام الواجب لمشاعر ومكونات أساسية في المجتمع، ويفتح الباب على مصراعيه لردود أفعال قد تزيد الوضع تعقيداً.
وأمام هذا الخطر المتمثل في التطرف الفكري والإقصاء، يبرز القبول الحقيقي للآخر، بكل تنوعه واختلافه، ليس مجرد موقف أخلاقي نبيل، بل هو شرط أساسي للتمكين والاستقرار والازدهار في الأرض. فحين ننظر إلى مجتمعات استطاعت تحقيق درجات من التقدم، نجد أن قدراً كبيراً من القبول والتسامح تجاه المكونات المختلفة، بما في ذلك السماح للمهاجرين بممارسة شعائرهم وبناء دور عبادتهم، كان عاملاً مساعداً. إن قوة الجزائر، كامنة ومستقبلية، تكمن في هذا التنوع الثري الذي يميز نسيجها الاجتماعي والثقافي.
ولتجسيد هذا القبول وتحرير هذه القوة الكامنة في التنوع، لا بد من توفير الظروف الحقيقية لكل مكونات الشعب الجزائري ليجدوا مكانتهم ويساهموا بفاعلية: الأمازيغ بتنوع لهجاتهم وثقافاتهم، الشاوية، التوارق، بني مزاب، وحتى التيارات الفكرية المختلفة كأنصار القومية العربية أو التوجهات الدينية كالسلفيين، ما دام الجميع يعمل تحت مظلة الوطن وقوانينه. لكن توفير هذه الظروف يتطلب قيادة وطنية تتجاوز الانتماءات الضيقة؛ قيادة لا تخضع لأي تيار أيديولوجي أو جهوي، رئيس يكون فوق كل الانتماءات ويعمل لصالح الجميع. تخيل للحظة وصول شخصية مثل الدكتور بلغيث، أو ممثل لتيار إخواني أو سلفي متشدد، إلى سدة الحكم؛ ألن يعني ذلك بالضرورة محاولة فرض رؤية واحدة وإلغاء أو تهميش كل من يخالفها، مما قد يقود البلاد نحو الانهيار؟ ومن هنا، تبدو سياسات مثل التعريب القسري أو الإقصائي خطأً استراتيجياً، لأن تعميم استخدام لغة واحدة بالقوة يعني بالضرورة إقصاء مكونات أساسية أخرى من الشعب، سواء أولئك الذين لغتهم الأم هي الأمازيغية بلهجاتها المختلفة، أو حتى شريحة واسعة تلقت تكويناً باللغة الفرنسية وتمتلك كفاءات عالية. فالمبدأ الأساسي يجب أن يكون: لا للإقصاء. فتخيل وجود كفاءة وطنية قادرة على تقديم مساهمات جبارة لتطوير البلاد وتسييرها بامتياز، ولكنها تجيد التعبير عن أفكارها وخططها بالأمازيغية أو التارقية أو حتى الفرنسية بشكل أفضل؛ هل نحرم الوطن من هذه الكفاءة بسبب حاجز اللغة المفروض؟ إن احتضان الجميع، وتمكين الكفاءات بغض النظر عن لغتها أو خلفيتها، هو السبيل الوحيد لبناء جزائر قوية وموحدة ومزدهرة.
وبينما يُعد بناء هذه الوحدة الداخلية القائمة على الاحتواء أمراً حيوياً، فإن الانغماس المفرط في النقاشات الحادة حول الهوية، كتلك التي أثارتها تصريحات بلغيث، يمثل توجيهاً للأسهم نحو الداخل، نحو نقاط الخلاف والانقسام، بينما الأجدى والأكثر إلحاحاً هو توجيه كل الطاقات نحو الخارج بمعناه التنموي: بناء الطرقات، تحسين جودة التعليم والتكوين المهني، استقطاب الاستثمارات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين. قد يطرح التساؤل المشروع: لماذا لا تزال الجزائر، رغم إمكانياتها الهائلة، لم تحقق التقدم المنشود؟ ربما تكمن إحدى الإجابات في أن معادلة التقدم لا تكتمل أركانها إلا بوجود وعي جمعي لدى الشعب يدفع نحو البناء ويحافظ على المكتسبات.
اجمالي القراءات
1752